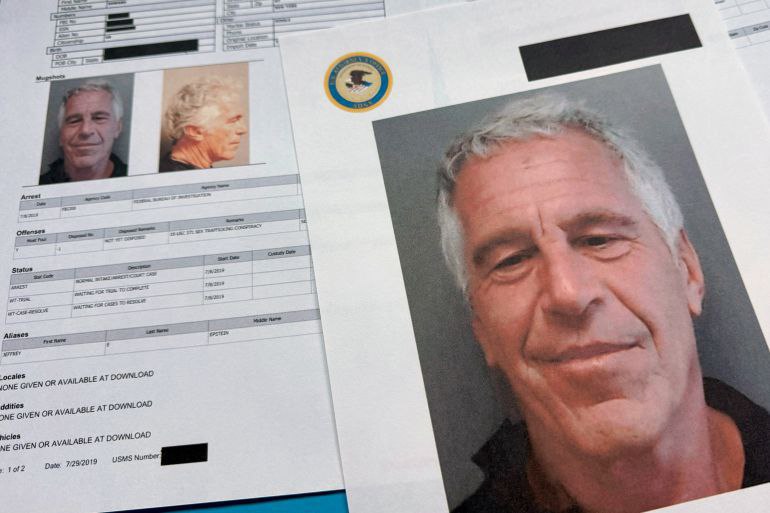مدرسة الانتخابات الإسلامية
- ودق - Wadaq
- سبتمبر 30, 2025
- مقالات
- أحمد خليف, الانتخابات, الانتخابات والاسلام, فقه الانتخابات, مقالات
- 0 Comments
ودق – أحمد خليف
اليوم يكاد لا يخلو بلد من نظام انتخابي يُقدَّم على أنه الآلية الأمثل لاختيار القيادة وممثلي الشعب، فالانتخابات الحديثة تقوم على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الإرادة الجماعية للأمة تُترجم عبر صناديق الاقتراع إلى شرعية للحاكم.
لكن هذا المفهوم، على حداثة صياغته القانونية، ليس جديداً من حيث المبدأ، إذ عرف المسلمون منذ صدر الإسلام أسلوباً مميزاً في اختيار قادتهم عُرف بالشورى والبيعة، وهو أسلوب يجمع بين روح المشاركة الجماعية وبين الضوابط الشرعية والأخلاقية.
الفرق بين الشورى والديمقراطية يبرز منذ البداية:
الديمقراطية – وفق النموذج الغربي – تجعل إرادة الأغلبية هي المرجع الأعلى، حتى وإن تعارضت مع ثوابت أخلاقية أو دينية.
بينما الشورى الإسلامية تضبط إرادة الجماعة بمرجعية الشرع.
فهنا يختار الناس من يحكمهم، نعم، لكن اختيارهم مشروط بأن يكون المرشح ملتزماً بأحكام الدين وقيم العدل والأمانة، فلا يصح أن يُقدَّم للقيادة من لا يصلح ديناً أو خُلقاً أو كفاءة.
وهذا يفسر لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من طلب الإمارة، ولماذا اعتبرها أمانة عظيمة وليست امتيازاً شخصياً.
أما البيعة فهي الوجه العملي للشورى، فهي العقد الذي يربط بين الحاكم والأمة، والبيعة في جوهرها لا تختلف كثيراً عن مفهوم “العقد الاجتماعي” الذي تتحدث عنه الفلسفات السياسية الحديثة، لكنها تتميز بكونها عقداً ذا طبيعة دينية وأخلاقية، لا مجرد اتفاق سياسي.
فعندما يبايع المسلمون قائدهم، فإنهم يلتزمون بطاعته في المعروف، وهو بالمقابل يلتزم بالعدل والقيام على مصالح الأمة.
ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطاب له بعد البيعة: “أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم”.
هنا يظهر بوضوح أن الشرعية في الإسلام ليست مطلقة، بل مقيدة بشرط الالتزام بالشرع.
إذاً، حين نتحدث عن “مدارس الانتخابات في الإسلام”، فإننا لا نقصد شكليات الانتخابات الحديثة (الصناديق، الحملات، الأصوات الإلكترونية)، بل نقصد تلك المبادئ الجوهرية التي وضعها الإسلام: الشورى، البيعة، النصيحة، المحاسبة. وهذه المبادئ هي التي تحدد معالم العملية كلها:
– من يحق له الترشح وكيف يُختار؟
– من يملك حق الانتخاب ومتى يكون ملزماً؟
– من يراقب العملية ويضمن نزاهتها؟
– وما العلاقة بين الحاكم والأمة بعد توليه الحكم؟
التاريخ الإسلامي يقدم لنا نماذج ثرية للإجابة عن هذه الأسئلة.
الرؤية الإسلامية للانتخابات ليست مجرد “شكل سياسي”، بل “قيمة أخلاقية”
فاختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة كان أقرب ما يكون إلى اجتماع طارئ للناخبين الأساسيين (المهاجرون والأنصار) الذين تناقشوا ثم توافقوا على المرشح.
أما اختيار عمر رضي الله عنه فجاء بترشيح مباشر من أبي بكر مع قبول الأمة. بينما اختيار عثمان رضي الله عنه كان عبر لجنة شورى محدودة العدد، وفي النهاية تمت مبايعته من عامة المسلمين.
وعلي رضي الله عنه تمت بيعته بعد فراغ سياسي كبير، مما أبرز أن الأمة هي المرجع الأخير في إضفاء الشرعية.
هذه التجارب المختلفة تؤكد أن الإسلام لم يلزم بأسلوب واحد جامد، بل ترك مساحة واسعة للاجتهاد بحسب الزمان والمكان، مع الالتزام بالثوابت الشرعية.
من هنا ندرك أن الرؤية الإسلامية للانتخابات ليست مجرد “شكل سياسي”، بل “قيمة أخلاقية”، فالإسلام يجعل الحكم أمانة، ويجعل اختيار الحاكم واجباً دينياً، ويجعل مراقبته ومحاسبته جزءاً من الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”.
فالمسلم ليس مجرد ناخب يضع ورقة في صندوق، بل هو شريك في صناعة القرار، وملزم شرعاً بأن يقول الحق ويحاسب القائد إذا انحرف.
في ضوء ذلك، قررت كتابة هذا السرد ليقدم قراءة تحليلية لموضوع الانتخابات في الإسلام من خلال ثلاثة محاور أساسية:
1 – المرشحون
2 – الناخبون
3 – المراقبون
وسنحاول أن نبين كيف عالج الإسلام هذه الجوانب بنصوصه الشرعية وتجارب تاريخه، ثم نقارنها بما عليه النظم الانتخابية الحديثة.
الهدف من هذا ليس مجرد المقارنة، وإنما محاولة لإبراز أن الإسلام، منذ أربعة عشر قرناً، وضع أصولاً متينة لمشاركة الأمة في صناعة القرار، أصولاً يمكن أن تلهم العالم حتى اليوم.
آ – الأساس الشرعي للشورى والانتخابات في الإسلام
إن البحث عن شرعية الانتخابات في الإسلام يبدأ من أصل أعظم قررته الشريعة، وهو أن الحكم في الإسلام أمانة ومسؤولية، لا ينعقد إلا برضا الأمة واختيارها، ولا تستقيم طاعته إلا في حدود ما يوافق شرع الله، فالإسلام لم يجعل الحكم ميراثاً عائلياً ولا امتيازاً طبقياً، بل نصّ القرآن على أن أمر الأمة يقوم بالشورى:
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ الشورى: ٣٨
هذه الآية جاءت تمدح المؤمنين وتجعل الشورى سمة عامة في شؤونهم، مما يفيد أن إدارة شؤون الأمة لا تكون بانفراد حاكم ولا بفرض من خارج إرادتها، بل بمشاركة جماعية تقود إلى الرضا العام.
ثم جاء التطبيق العملي في حياة النبي عليه الصلاة و السلام، فقد مارس الشورى مع أصحابه في القضايا الكبرى، شاورهم يوم بدر في الخروج لملاقاة العدو، ويوم أحد في كيفية القتال، ويوم الخندق في الحصار، بل أقرّ برأي الحباب بن المنذر في تحديد موضع النزول ببدر.
هذه الممارسات تؤكد أن الشورى أصل تعبّدي وسياسي في الوقت نفسه.
ب – من الشورى إلى اختيار القيادة
بعد وفاة النبي عليه الصلاة و السلام واجه المسلمون أول اختبار عملي لاختيار القيادة، فاجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة للتشاور حول من يتولى الخلافة، ولم يكن هناك نص صريح يعيّن خليفة بعينه، فترك الأمر لاجتهاد الأمة واختيارها، تم النقاش، وتداولت الحجج بين المهاجرين والأنصار، ثم وقع الاتفاق على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتمت البيعة في اليوم نفسه، ثم تتابع الناس على بيعته.
هذا الحدث التاريخي المبكر يبيّن أن الأمة لم تعرف استلام السلطة بالقوة أو الوراثة، بل عمدت إلى الحوار والشورى والاختيار.
فالبيعة التي جرت لأبي بكر كانت بمثابة انتخاب حر مباشر من أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين.
ولما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه، رشّح عمر بن الخطاب للخلافة، لكنه لم يفرضه فرضاً، بل استشار الصحابة واستطلع رضاهم، ثم ترك الأمر للأمة إن أرادت قبول ترشيحه، فكان قبول الأمة لهذا الترشيح بمثابة انتخاب جديد.
وعندما أوصى عمر رضي الله عنه بأن يكون الأمر بعده شورى بين ستة من كبار الصحابة، فقد وضع نموذجاً آخر للاختيار الجماعي المنظّم، حيث اتفقت اللجنة على ترشيحين، ثم رجّح المسلمون عثمان رضي الله عنه وبايعوه.
أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد بايعه المسلمون بعد مقتل عثمان، حين احتاجت الأمة إلى قائد يجمع كلمتها، فتمت البيعة العامة من أهل المدينة ثم من عامة الأمصار.
هذه الوقائع التاريخية تدل على أن الشورى ليست مبدأً نظرياً فحسب، بل هي أداة عملية لاختيار القيادة في الإسلام، وأن الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد وعامة المسلمين هي صاحبة الحق في منح الشرعية للحاكم من خلال البيعة.
جـ – البيعة عقد شرعي واجتماعي
البيعة في اللغة هي العهد، وأصلها من “المبايعة” التي تكون في البيع، إذ يضع المتبايعان أيديهما في أيدي بعض علامة على الرضا والقبول، وفي الاصطلاح الشرعي هي عقد بين الأمة والحاكم، يلتزم فيه الناس بالطاعة في المعروف، ويلتزم فيه الحاكم بإقامة العدل ورعاية المصالح.
وقد صرّح القرآن بمبدأ الطاعة المقيدة حين قال:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ النساء. ٥٩
فقوله “منكم” يدل على أن ولي الأمر يخرج من الأمة وباختيارها، وأن طاعته تابعة لطاعة الله ورسوله.
وقال النبي عليه الصلاة و السلام في حديث عبادة بن الصامت:
“بايعنا رسول الله عليه الصلاة و السلام على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً”
فهذه البيعة أصل لكل عملية اختيار سياسي في الإسلام، وهي ليست مجرد احتفال شكلي، بل عقد ملزم للطرفين.
د- الانتخابات المعاصرة والشورى
عندما ننظر اليوم إلى الانتخابات الحديثة نجد أنها في جوهرها وسيلة لمعرفة إرادة الأمة، فإذا تم ضبط هذه الوسيلة بضوابط الشرع ومقاصده، فهي امتداد لمبدأ الشورى وليست بدعة في أصلها، لأنها تحقق غرضاً معتبراً وهو اختيار الأمة لمن يقودها، لكن الفرق الأساسي يكمن في المرجعية:
– فالإسلام يجعل إرادة الأمة محكومة بالشرع
– أما النظم الديمقراطية فتعطي للأغلبية سلطة التشريع المطلق
من هنا قرر العلماء المعاصرون أن آليات الانتخاب المعروفة اليوم ليست محرّمة في ذاتها، وإنما حكمها يدور مع مقصدها، فإن استُخدمت لاختيار الأصلح ممن تتوافر فيه شروط الولاية الشرعية، فهي مشروعة ومطلوبة، وإن استُخدمت لتقديم من لا يصلح أو لإقصاء أهل الكفاءة والدين، فهي محرّمة ومردودة.
المرشحون
إذا كان الإسلام قد جعل الحكم أمانة ومسؤولية، فإن الترشح لهذا المنصب لا يكون مفتوحاً لكل أحد، بل قيده بضوابط شرعية وأخلاقية تضمن أن يصلح القائد لقيادة الأمة، وهنا يختلف المنظور الإسلامي عن المنظور الديمقراطي المعاصر.
فبينما تركز الانتخابات الحديثة على عدد الأصوات بغض النظر عن صفات المرشح، فإن الإسلام يضع شروطاً جوهرية لا بد من تحققها قبل النظر في ترشيح أي شخص.
ما هي الشروط الأساسية للمرشح؟
اتفق الفقهاء على أن المرشح للإمامة أو القيادة العامة يجب أن تتوافر فيه جملة من الصفات، أهمها:
- العدالة:
أي أن يكون معروفاً بالاستقامة وحسن السيرة، بعيداً عن الكبائر والفواحش، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ النساء: ٥٨.
والقيادة أمانة كبرى، فلا بد أن تُعطى لمن عُرف بالعدالة.
- العلم والكفاءة:
فلا يكفي أن يكون صالحاً في نفسه، بل لا بد أن يكون قادراً على إدارة شؤون الأمة بعلم وحكمة. ولهذا قال الفقهاء: يشترط أن يكون قادراً على الاجتهاد في النوازل الكبرى، أو محيطاً بأصول الحكم والسياسة الشرعية.
- الأمانة والصدق:
وهي صفة لازمة، لأن الحاكم مؤتمن على أموال الناس وأعراضهم وأمنهم. وقد مدح الله نبيه يوسف عليه السلام بقوله: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ يوسف: ٥٥، أي أمين على المال، عليم بإدارته.
- القدرة والشجاعة:
إذ لا يكفي أن يكون صالحاً وعالماً، بل يجب أن يكون قوياً في مواجهة التحديات، قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ القصص: ٢٦.
- سلامة الحواس والأعضاء:
القائد يحتاج إلى إدراك سليم يمكنه من مباشرة مهامه وهو بكامل قواه العقلية و الجسدية.
هذه الشروط مجتمعة تؤكد أن القيادة في الإسلام ليست ميدان طموح شخصي، بل هي تكليف ثقيل لا يُعطى إلا لمن اجتمع فيه الدين والكفاءة.
ما هي ضوابط الترشح؟
حتى مع توافر الشروط، فإن الإسلام وضع ضوابط دقيقة للعملية:
- النهي عن طلب الإمارة:
فقد قال النبي عليه الصلاة و السلام لعبد الرحمن بن سمرة: “يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها”.
هذا يدل على أن طلب المنصب لذاته مذموم، لكن العلماء بيّنوا أن الترشح جائز إذا قصد المرء به الإصلاح وخدمة الأمة، لا مجرد الجاه والسلطان، (طبعاً أنا مع رأي العلماء لكن فقط ذكرت النقطة للعلم بالشيء).
- تحريم شراء الأصوات أو الرشوة:
فالإسلام يجعل الاختيار أمانة، فلا يجوز التأثير عليه بالمال أو النفوذ. قال النبي عليه السلام: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
- الترشح ليس حقاً مطلقاً:
بل مقيد بتحقق الشروط السابقة، فالذي لا تتوافر فيه الكفاءة أو العدالة لا يجوز له أن يرشح نفسه، حتى وإن نال أصوات الأغلبية.
- التاريخ الإسلامي يقدم صوراً بليغة في هذا الباب:
أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يرشح نفسه، بل رُشِّح من الصحابة لما عرفوا فيه من صفات الصدق والقوة في الدين، وكان أقربهم إلى النبي عليه الصلاة و السلام.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُشِّح من أبي بكر لا لقرابته، وإنما لكفاءته وقوته في الحق، وقد اشتهر بصرامته وعدله.
عثمان بن عفان رضي الله عنه اختير بعد منافسة شريفة في لجنة الشورى، حيث تنازل علي وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم عن أنفسهم، ولم يكن هناك شراء أصوات ولا دعاية فارغة، بل نقاش صادق حول الأصلح للأمة.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسعَ إلى المنصب، بل ألحّت عليه الأمة بعد مقتل عثمان، فقبل مضطراً لإصلاح ما فسد.
هذه النماذج تؤكد أن الترشح في الإسلام لا يقوم على التنافس الشخصي والبحث عن مكاسب، وإنما على ترشيح الأمة للأصلح ممن اجتمعت فيه الصفات المطلوبة.
الناخبون
إن الإسلام وضع شروطاً دقيقة للمرشحين، فإنه لم يُغفل جانب الناخبين، أي من يحق لهم المشاركة في اختيار القيادة، فالاختيار في الإسلام ليس عملاً شكلياً، بل هو شهادة ومسؤولية شرعية، لأن الناخب حين يختار إنما يشهد بأن المرشح صالح وكفؤ.
قد قال الله تعالى:
﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ الطلاق: ٢
– أهل الحل والعقد
في التاريخ الإسلامي الأول، كان الدور الأبرز في اختيار الخليفة لما يُسمَّى أهل الحل والعقد، وهم كبار الصحابة والعلماء ووجهاء القبائل وقادة الرأي، وهؤلاء يمثلون صفوة الأمة الذين يُرجع إليهم في القرارات الكبرى، لأنهم أعلم بمصالحها وأقدر على تمييز الأصلح.
في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، كان اجتماع السقيفة بين كبار المهاجرين والأنصار.
في بيعة عثمان رضي الله عنه، كانت لجنة الشورى المكوّنة من ستة من كبار الصحابة.
في بيعة علي رضي الله عنه، كان أهل المدينة وأهل الرأي هم الذين بادروا بالبيعة أولاً.
لكن مع ذلك لم يكن دور الأمة العامة مغيباً، بل إن بيعة العامة كانت شرطاً لاستقرار الشرعية، فالبيعة لا تكتمل حتى يبايع الناس بعد أهل الحل والعقد، وإلا بقيت ناقصة.
– عموم الأمة
رأى بعض الفقهاء أن البيعة لا تقتصر على النخبة، بل تشمل الأمة كلها بقدر الإمكان، لأن الهدف هو الرضا العام، فالخلافة عقد بين الحاكم والأمة، ولا يكفي أن يعقده نفر قليل دون بقية الناس، ومن هنا كانت البيعة في عهد الخلفاء الراشدين ذات شقين:
أولاً – بيعة خاصة من أهل الحل والعقد.
ثانياً – بيعة عامة من عموم المسلمين.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
“لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة”.
وهذا يدل على أن الأمة كلها معنية بالاختيار والقبول.
ما هي شروط الناخبين؟
بما أن التصويت شهادة، فقد اشترط العلماء في الناخبين عدة صفات:
– العدالة: أي أن يكون معروفاً بالاستقامة، فلا يُقبل رأي فاسق أو خائن للأمانة.
– العلم أو الخبرة: لا يشترط أن يكون عالماً بالفقه، لكن ينبغي أن يملك القدرة على التمييز بين الأصلح والأفسد.
– الحرية والإرادة: فلا يجوز إكراه الناس على بيعة أو اختيار، لأن الإكراه يبطل معنى الشورى.
– المصلحة العامة: أن يقصد باختياره مصلحة الأمة لا مصلحة شخصية أو عصبية قبلية.
ما هي مسؤولية الناخب؟
النصوص الشرعية تجعل الناخب مسؤولاً أمام الله عن صوته. قال النبي صل الله عليه و سلم: “إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة”.
وسُئل: كيف إضاعتها؟ قال: “إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة” (البخاري).
والانتخاب في جوهره هو عملية إسناد للأمر، فمن أعطى صوته لغير أهل الكفاءة فقد خان الأمانة.
مع تطور النظم السياسية، أصبح السؤال:
هل يجوز أن يشارك عامة الناس جميعاً في التصويت كما هو الحال في الانتخابات الحديثة؟
أجاب العلماء المعاصرون أن هذا جائز بل مطلوب، لأن توسيع دائرة الشورى يحقق مقصد الرضا العام، شرط أن تُضبط العملية بضوابط الشرع، وأن يُقدَّم فيها الأصلح.
بل إن بعضهم اعتبر أن مشاركة عموم الناس صورة معاصرة من البيعة العامة التي عرفها المسلمون قديماً.
3 – المراقبون
كانت الانتخابات في الإسلام لا تتوقف عند لحظة اختيار القائد، بل تمتد إلى ما بعدها، حيث تبرز أهمية الرقابة والمحاسبة، وهي وظيفة يقوم بها العلماء وأهل الرأي وعامة الأمة.
فالإسلام جعل الحاكم مسؤولاً أمام الله أولاً ثم أمام الناس، وأعطى الأمة حقاً بل واجباً في مراقبته وتقويمه.
قال النبي صلى الله عليه و سلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (مسلم).
فالنصيحة للحاكم واجبة، وهي تشمل تقويمه ونقده إذا أخطأ.
وقال عليه الصلاة و السلام: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (النسائي).
أي أن مقاومة الظلم ومحاسبة الحاكم من أعظم مراتب الجهاد.
وقال عمر رضي الله عنه: “لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها”، يقصد النقد والمساءلة.
نجد هنا من خلال هذه النصوص أن الرقابة جزءاً من الدين، لا مجرد عمل سياسي.
ما هي أشكال الرقابة في الإسلام؟
– رقابة أهل الحل والعقد:
فهم بمثابة البرلمان أو المجلس الاستشاري، يراقبون أداء الحاكم، وينصحونه، ويعترضون إن خالف الشرع أو ظلم.
– رقابة العلماء:
العلماء لهم مكانة خاصة باعتبارهم أهل العلم والفتوى، وكثيراً ما كانوا يواجهون الحكام بالحق، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن.
– رقابة الأمة:
عامة الناس لهم حق الاعتراض وإبداء الرأي، وقد روي أن امرأة اعترضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة المهر، فأقرّها وقال: “أصابت المرأة وأخطأ عمر”.
– المؤسسات الرسمية:
نشأ في التاريخ الإسلامي نظام الحسبة، وهو جهاز رقابي يتابع الأسواق والمجتمع، ويشرف على العدل ومنع الفساد، ويمكن اعتباره نواة مبكرة لهيئات الرقابة في النظم الحديثة.
قام الإسلام بضبط الرقابة بحدود شرعية:
العدل والإنصاف، فلا يجوز اتهام الحاكم بغير دليل.
السرية والعلنية، الأصل أن تكون النصيحة سراً، لكن إذا كان الظلم علنياً جاز الإنكار علناً.
الطاعة في المعروف، الحاكم يُطاع في ما لا يخالف الشرع، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له.
في عهد عمر رضي الله عنه، كان الناس يوقفونه في المسجد ويسألونه عن لباسه أو ماله، فيجيب ويبرر.
وفي عهد عثمان رضي الله عنه، كثرت الاعتراضات حتى وصلت إلى الثورة عليه، مما يدل على أن الرقابة الشعبية كانت قوية، وإن اختلطت أحياناً بالمصالح السياسية (طبعاً أنا اذكر هنا مثال فقط على الرقابة الشعبية لكن لا أؤيدها بحق عثمان رضي الله عنه).
وفي عهد علي رضي الله عنه، لم يتوقف خصومه عن محاسبته، حتى وإن بالغوا في المعارضة، لكنه ظل يؤكد أن النقد حق مشروع.
إذا قارنا الرقابة الإسلامية بالأنظمة الحديثة نجد تشابهاً في الجوهر:
وجود مجالس تشريعية أو رقابية.
دور الإعلام والمجتمع المدني.
لكن الفرق أن الرقابة في الإسلام ليست مجرد حق سياسي، بل هي واجب ديني يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هـ – آليات الاختيار
الانتخابات الحديثة تُعرّف عادةً بأنها “آلية إجرائية” تعتمد على صناديق الاقتراع والأصوات، بينما الإسلام لم يضع شكلاً واحداً جامداً، بل ترك الباب مفتوحاً لطرق متعددة، المهم أن يتحقق مقصد الشورى والرضا العام، وقد تجلت هذه الآليات في التاريخ الإسلامي بأكثر من صورة.
1- الشورى المباشرة
وهي الآلية الأولى التي ظهرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة و السلام، حين اجتمع كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وتناقشوا واختلفوا ثم اتفقوا على ترشيح أبي بكر رضي الله عنه.
هذه الصورة تشبه ما يسمى اليوم “الانتخابات المباشرة” حيث يجتمع الناخبون الأساسيون ويتحاورون حتى يصلوا إلى اتفاق.
2 – الترشيح مع الشورى
في بعض الحالات قام الحاكم السابق بترشيح من بعده، كما فعل أبو بكر عندما رشح عمر رضي الله عنه، لكنه لم يفرضه بالقوة، بل استشار الناس، ولما قبلوا مضى الأمر. هذه الصورة تشبه “الترشيح المسبق” الذي يحتاج لموافقة الأمة.
3 – لجنة الشورى المحدودة
وهو النموذج الذي وضعه عمر رضي الله عنه قبل وفاته، إذ جعل الأمر شورى بين ستة من كبار الصحابة، وترك لهم أن يختاروا واحداً. هذه الطريقة كانت بمثابة انتخابات عبر هيئة صغيرة تمثل الأمة، وهي أقرب لما نعرفه اليوم من “الانتخابات غير المباشرة” أو اختيار الرئيس عبر مجلس منتخب.
4 – البيعة العامة
بعد أن يتم الترشيح أو الاتفاق من أهل الحل والعقد، يأتي دور البيعة العامة، حيث يبايع عامة المسلمين القائد الجديد، وهذا ما حدث في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إذ لم تقتصر على الخاصة، بل تمت في المسجد أمام الناس جميعاً. هذه البيعة العامة هي بمثابة الاستفتاء الشعبي في النظم الحديثة.
5 -القبول الشعبي كشرط للشرعية
من المهم هنا أن نلاحظ أن الشرعية لا تكتمل إلا برضا الناس. فقد قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: “وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني”.
هذا يعني أن قبول الأمة ومشاركتها شرط أساسي، وليس مجرد إجراء تكميلي.
6- المرونة في الآليات
التجارب الأربعة للخلفاء الراشدين تؤكد أن الإسلام لم يحصر الأمة في طريقة واحدة للاختيار:
– اجتماع مباشر (سقيفة).
– ترشيح مع مشاورة (عمر).
– لجنة شورى (عثمان).
– بيعة عامة بعد فراغ سياسي (علي).
هذه المرونة تتيح للأمة في كل زمان أن تختار الآلية المناسبة لها، ما دامت تحقق المقصود: اختيار الأصلح برضا الناس وبضوابط الشرع.
7- ربط الشورى بالانتخابات الحديثة
يمكن القول إن الانتخابات الحديثة هي تطوير تقني لفكرة الشورى والبيعة:
– صناديق الاقتراع اليوم تقوم بدور “البيعة العامة”.
– البرلمانات والهيئات التشريعية تقوم بدور “أهل الحل والعقد”.
– الترشيح الحزبي أو الفردي يشبه ما فعله الصحابة من ترشيح للأصلح.
لكن الاختلاف الجوهري يكمن في المرجعية:
– فالشورى الإسلامية مقيدة بالشرع.
– بينما الانتخابات الحديثة قد تأتي بأي شخص يختاره الناس ولو كان فاسقاً أو ظالماً.
عند النظر في التجربة الإسلامية الأولى وما رسخته من مفاهيم الشورى والبيعة، ثم مقارنتها بالانتخابات الحديثة في الدول المعاصرة، نجد أن هناك مساحات من التشابه والاختلاف، بعضها جوهري وبعضها شكلي.
آ – أوجه التشابه
– مشاركة الأمة في الاختيار:
الانتخابات الحديثة تقوم على أن الشعب هو من يختار حكامه، وكذلك الشورى الإسلامية تقر أن الأمة لا بد أن ترضى بمن يقودها عبر البيعة.
– الشرعية من رضا الناس:
في الديمقراطية لا يُعتبر الحاكم شرعياً ما لم يأت عبر الانتخابات، وفي الإسلام لا تنعقد الخلافة إلا ببيعة الناس.
– دور النخبة والعامة معاً:
في النظم الحديثة هناك برلمانات وأحزاب ونخب سياسية، وفي الإسلام كان هناك أهل الحل والعقد والعلماء والوجهاء، إلى جانب البيعة العامة.
– التعدد في طرق الاختيار:
كما تختلف النظم الانتخابية المعاصرة (مباشرة، غير مباشرة، عبر أحزاب)، كذلك اختلفت طرق اختيار الخلفاء الراشدين.
ب- أوجه الاختلاف
الانتخابات ليست بدعة غريبة على الإسلام، بل هي امتداد معاصر لفكرة الشورى والبيعة، شريطة أن تُضبط بالضوابط الشرعية
-المرجعية العليا:
في الديمقراطية الحديثة، السيادة للشعب، والأغلبية يمكن أن تشرّع حتى ما يخالف الدين أو الأخلاق.
في الإسلام، السيادة للشرع، واختيار الأمة مقيد بأحكام القرآن والسنة، فلا يصح انتخاب فاسق أو ظالم ولو رضي به الناس.
-شروط المرشحين:
في النظم الحديثة قد يترشح أي شخص بالغ يحمل الجنسية.
في الإسلام الترشح مشروط بالعدالة والعلم والكفاءة والأمانة.
– الغاية من الحكم:
في الديمقراطية الهدف تنظيم السلطة وتحقيق مصالح الناس وفق إرادتهم.
في الإسلام الهدف إقامة العدل وحفظ الدين ومصالح الأمة في إطار الشرع.
– الرقابة بعد الاختيار:
في النظم الحديثة الرقابة من خلال البرلمان، الإعلام، المجتمع المدني.
في الإسلام الرقابة واجب ديني على كل فرد، وهي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– مفهوم الطاعة والمعارضة:
في الديمقراطية المعارضة قد تعني إسقاط النظام أو تعطيله.
في الإسلام الطاعة واجبة في المعروف فقط، والمعارضة مشروعة إذا خالف الحاكم الشرع أو ظلم.
ج- إمكان الاستفادة
رغم الاختلافات الجوهرية، فإن المسلم يمكن أن يستفيد من النظم الانتخابية الحديثة باعتبارها أدوات تقنية لتحقيق مقصود الشورى، مثل:
– صناديق الاقتراع لضبط عملية البيعة العامة.
– القوانين المنظمة للترشح لضمان النزاهة.
– المجالس المنتخبة لتوسيع دائرة الشورى.
وبهذا نستطيع القول إن الانتخابات ليست بدعة غريبة على الإسلام، بل هي امتداد معاصر لفكرة الشورى والبيعة، شريطة أن تُضبط بالضوابط الشرعية، فلا يُقدَّم فيها غير الأكفّاء، ولا تتحول إلى صراع حزبي أو شراء للأصوات.
من خلال استعراض الأساس الشرعي للشورى والبيعة، وشروط المرشحين وضوابطهم، ودور الناخبين